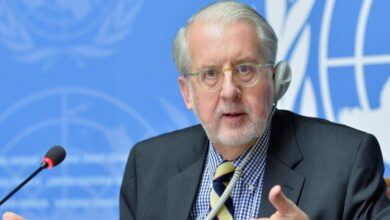السويداء.. إجلاء دفعة جديدة من عشائر البدو إلى درعا

خرج في وقت متأخر من مساء الجمعة 25 من تموز 210 أشخاص من عشائر البدو في محافظة السويداء باتجاه درعا عبر معبر بصرى الشام، ضمن القافلة الخامسة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن القافلة تضم حوالي 20 مريضًا ورعايا أجانب، دون معلومات عن جنسيتهم.
وبذلك يكون العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم من السويداء ضمن القوافل الخمس هو 1638 شخصًا.
وأعلن “الهلال الأحمر السوري” وعدد من المنظمات الأممية اليوم، السبت 26 من تموز، إرسال قافلة مساعدات إنسانية من دمشق إلى محافظة درعا، لتعزيز الاستجابة الإغاثية للأسر المتضررة.
مدير وحدة الإعلام والتواصل في “الهلال الأحمر”، عمر المالكي، قال إن القافلة تتكون من 17 حافلة، تتضمن مواد غذائية معلبة، ومستهلكات طبية، ومياه شرب، وحفاظات أطفال،و مواد خاصة للعائلات الوافدة والمجتمعات المضيفة، بحسب ما نقلته “سانا“.
و أرسلت هذه القوافل بناء على تقييم ميداني بالتعاون مع غرف عمليات محافظة درعا، حيث يتم التنسيق معهم لفهم الاحتياجات الأساسية في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، وبناء عليه يتم تجهيز قوافل المساعدات وإعداد المواد اللازمة، وفق المالكي.
وبيّن أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة الجنوبية كبيرة ومتنوعة، مع وجود أعداد كبيرة جدًا من المتضررين غير المباشرين من عائلات وافدة ومستضيفة، ما يزيد من حجم الطلب على المواد الأساسية كالطحين والمياه والمازوت.
ولفت المالكي إلى أن الهلال الأحمر يرسل قوافل بشكل شبه يومي إلى محافظتي درعا والسويداء، مع تقديم الدعم بالمستهلكات، والسلات الغذائية، والمياه، والمازوت، بالتعاون مع شركاء محليين من جمعيات ومتطوعين من مختلف المحافظات.
وضع “مزرٍ”
وصف ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو بارغاس يوسا، الوضع في درعا وريف دمشق بالكارثي.
وقال في منشور له على “إكس“، الجمعة 25 من تموز، إن أعداد النازحين من محافظة السويداء إلى درعا وريف دمشق يقدر بنحو 176 ألف شخص.
وأجرت المفوضية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، تقييمًا للوضع في محافظة درعا وريف دمشق ووصفته بـ”المزري”، وفق يوسا.
كما بيّن أن المفوضية تعمل على زيادة دعمها بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، حيث تقوم بتوزيع مجموعات الطوارئ وتوفير خدمات الحماية وتقديم الدعم النفسي ودعم الأطفال.
ولفت يوسا إلى أنه تم توزيع مواد الطوارئ على 3570 نازحًا، و إرسال 2500 مجموعة طوارئ إلى درعا وريف دمشق، و2000 مجموعة إلى السويداء.
وتقدم المفوضية خدمات الحماية الأساسية، بما فيها الدعم النفسي بحالات الطوارئ وأنشطة حماية الطفل، من خلال مراكزها المجتمعية في المناطق المتضررة، وفق يوسا.
وأشار إلى أن المفوضية حافظت على وجودها في السويداء طوال حالة الطوارئ.
إجلاء مؤقت
مع انطلاق قافلة العائلات الأولى، صدّرت الحكومة السورية المسألة على أنها إجلاء “مؤقت” لحين تهدئة الأوضاع في السويداء، الأمر الذي لا وجود لمؤشرات واضحة عليه حتى الآن.
قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، صرح بالتزام الحكومة بتأمين خروج العائلات المحتجزة والراغبين بمغادرة محافظة السويداء من جميع الشرائح، مع توفير إمكانية الدخول إليها للراغبين بذلك، وفق تصريحه.
المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أكد بدوره أن خروج العائلات الطارئ من المحافظة “مؤقت” بسبب الظروف الإنسانية والأمنية، وستكون عودتهم قريبة للمدينة بعد تأمين المحافظة وفق قوله.
لا تزال محافظة السويداء تشهد أزمة أمنية وإنسانية، عقب أحداث عنف وانتهاكات مارستها كل من الحكومة ومسلحين يتبعون للعشائر وفصائل محلية موالية للرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري.
بدأت الأحداث عقب حالات خطف متبادل بين عشائر البدو في السويداء وفصائل محلية ذات طابع درزي، أعقبها دخول الحكومة السورية والتي لاقت مقاومة وقصفًا من إسرائيل مازاد في تعقيد المشهد.
وفق أحدث إحصائية صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قتل ما لا يقل عن 814 سوريًا بينهم 34 سيدة و 20 طفلًا، وستة أشخاص من الطواقم الطبية، وشخصين من الطواقم الإعلامية، في محافظة السويداء منذ اندلاع التوترات في 13 من تموز الحالي.
وأصيب ما يزيد عن 903 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، علمًا أن هذه الحصيلة تخضغ لعمليات تحديث مستمرة وهي أولية، كما لا تزال الجهود جارية لتصنيف الضحايا بحسب الجهة المسؤولة عن الانتهاكات وتمييز صفتهم بين مدنيين ومقاتلين، وفق تقرير الشبكة المنشور في 24 من تموز.