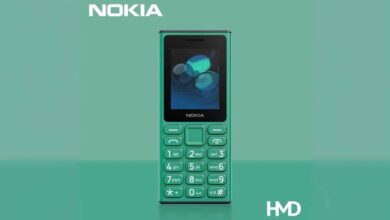لا حاجة إلى الترقية.. آبل تتيح مزايا صحية جديدة في ساعاتها القديمة


أعلنت شركة آبل مجموعة من المزايا الصحية الجديدة بالتزامن مع إطلاق الإصدارات الجديدة من ساعاتها الذكية، مؤكدةً أن هذه المزايا لن تقتصر على الساعات الجديدة فقط، بل ستتوفر لمستخدمي إصدارات سابقة أقدم مع تحديث watchOS 26 المقرر إطلاقه في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.
إشعارات ضغط الدم المرتفع
من أبرز تلك المزايا ميزة التنبيه بارتفاع ضغط الدم، التي تعتمد على مستشعر ضربات القلب البصري المدمج في الساعات لتحليل استجابة الأوعية الدموية لنبضات القلب.
وتعمل خوارزميات طوّرتها آبل على تحليل البيانات على مدى 30 يومًا لإخطار المستخدمين في حال وجود علامات تشير إلى ارتفاع ضغط الدم. وتقول آبل إنها تتوقع الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وجهات تنظيمية أخرى هذا الشهر، مع خطة لإطلاق الميزة في أكثر من 150 دولة حول العالم.
وستتوفر تلك الميزة في الجيل التاسع من ساعة آبل Apple Watch Series 9 فما أحدث، بالإضافة إلى ساعة Apple Watch Ultra 2 فما أحدث عند إصدار تحديث watchOS 26.
تحسينات تتبع النوم
أكدت آبل أن ميزة تقييم جودة النوم (Sleep Score)، التي توفرها للساعات الجديدة، سوف تكون متاحة أيضًا لمجموعة أوسع من ساعاتها الذكية، منها الجيل السادس Apple Watch Series 6 فما أحدث، إضافةً إلى كافة إصدارات Apple Watch Ultra والجيل الثاني من ساعة Watch SE فما أحدث.
وتعتمد هذه الميزة على بيانات معدل ضربات القلب وحرارة المعصم ونسبة الأكسجين في الدم ومعدل التنفس لتقديم تقييم شامل لجودة النوم عند الاقتران بهواتف آيفون 11 فما أحدث.
إيماءات جديدة وخصائص موسعة
ومن المقرر أن يحصل أيضًا مستخدمو الجيل التاسع Apple Watch Series 9 فما أحدث، إلى جانب ساعة Apple Watch Ultra 2، على ميزة الإيماءة السريعة Flick Gesture، إضافةً إلى الترجمة الفورية مباشرةً من المعصم.
وبهذا التحديث، تسعى آبل إلى توسيع نطاق الاستفادة من تقنياتها الصحية، دون إلزام المستخدمين بالترقية الفورية إلى أحدث الإصدارات.
Source link