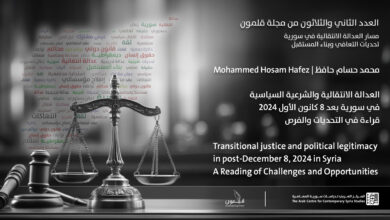حول اقتراح استبدال العملة الحالية بعملة جديدة في سورية

مقدمة
يُشبّه علماء الاقتصاد النقود في جسم الاقتصاد الوطني بالدم في جسم الإنسان، وقد عرفت البشرية خلال تطورها أشكالًا عديدة من التعامل النقدي، بدءًا من استخدام بعض المنتجات التي قامت بدور النقود كالملح مثلًا، ثم النقود المعدنية، ثم الورقية، وأخيرًا الإلكترونية. ومع تطور الاقتصاد وأنماط الإنتاج، تطورت النقود وتعددت وظائفها، ومع التطور التقني، أصبحت عمليات التبادل أكثر سهولة وأمانًا، وأصبح من المتعارف عليه في العلوم الاقتصادية أن النقود تقوم بعددٍ من الوظائف، هي 1) وسيط للتبادل، وهي أهم وأوسع وظيفة للنقد، حيث تستخدم النقود في سداد معاملات التبادل للسلع والخدمات؛ 2) مقياس للقيمة، بها تقاس القيم في السوق، وهي وظيفة أساسية للنقد حيث تحوّل السلع والخدمات إلى قيم محددة، من خلال عملها كمعيار مشترك؛ 3) معيار للمدفوعات المؤجلة، بمعنى أداة للدفع الآجل في المستقبل القريب أو المتوسط؛ 4) مخزن القيمة أو وظيفة الأصول للنقود، حيث وفّرت النقود إمكانية بيع المنتجات مع الاحتفاظ بالقيم لإنفاقها في المستقبل؛ 5) تكون وسيطًا للتبادل، فهي تُتيح استقلال عمليات البيع والشراء عن بعضها البعض، وتبيع لمشتر وتشري من بائع آخر في وقت آخر ومكان آخر.
إن تحوّل الاقتصادات على الصعيد العالمي، إلى اقتصادات نقدية، طرح على عاتق النقود أعباء ووظائف ذات أهمية كلية، اقتصادية وإنتاجية واجتماعية، وأصبحت السياسات المالية للحكومة معيارًا أساسيًا لنجاحها في أداء وظائفها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي التزمت بها في برامجها، ويحتلّ النقد وسعر الصرف حيزًا مهمًّا في السياسات المالية الحكومية ومؤسساتها المتخصصة، مثل البنك المركزي الذي تُوكل إليه عادة مهمة إصدار النقد وإدارته والحفاظ على قيمته وتعزيزها، والحفاظ على استقرار الأسعار، والحدّ من البطالة.
ثمّة عوامل داخلية، مثل فشل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتساع البطالة والعجز في ميزان المدفوعات، أو عدم الاستقرار السياسي واضطرابات اجتماعية، وعوامل خارجية مثل الأزمات الاقتصادية والسياسية وانتشار الأوبئة (مثل وباء كوفيد 19) الذي تسبب بتراجع المبادلات الدولية، وتراجع حركة الأفراد وتراجع العرض العالمي من السلع والخدمات، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاعات في الأسعار، وجميع هذه العوامل، إضافة إلى الحروب والكوارث الطبيعية، تؤدي إلى مشكلات اقتصادية ومالية للدول، تجد انعكاسها المباشر في سعر صرف عملاتها، وحجم كتلتها النقدية وأسعار الفائدة وغيرها، وتبين القراءة التاريخية أنه ليس هناك دولة بمنأى عن آثار هذه الأزمات أو الاضطرابات.
تفيدنا التجربة التاريخية بأن “الأزمة المالية العالمية”، بدأت مع ما يسمّى “الكساد الكبير” الذي بدأ في سوق الأسهم الأميركية عام 1929 واستمر حتى عام 1933، وكان قد انتقل تدريجيًا إلى معظم دول العالم، ولم تنجح العديد من الدول في التخلص من آثاره على الإنتاج والنمو الاقتصادي حتى نهاية عقد الثلاثينيات، وقد حفزت الأزمة الاقتصادية البريطاني جون ماينار كينز على إطلاق أهمّ أعماله (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقد) عام 1936. وفي عام 2008 ظهرت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، وكان أساسها نقديًا، وبدأت في البنوك، وانتقلت لتصبح أزمة مالية واقتصادية عالمية انعكست في تراجع مستويات الإنتاج ومعدلات التشغيل والبطالة ومعدلات النمو والأسعار ومستويات المعيشة، وأدّت إلى إفلاس ملايين من الأفراد وآلاف الشركات عبر العالم، ودفعت بالدولة كي تتدخل لمعالجة النتائج الكارثية لتلك الأزمة. وكانت الحروب العالمية والإقليمية ذات نتائج كارثية على اقتصادات الدول حتى تلك غير المشاركة فيها، أما الصراعات والحروب الداخلية التي انتشرت في عدد كبير من الدول منذ منتصف القرن الماضي، فقد كانت آثارها محدودة في الدول التي عانت منها إلا أن بعض آثارها أصابت جوارها القريب من الدول. ومن ثم تجد جميع الأزمات والحروب انعكاساتها النقدية.
تترافق الحروب والأزمات العالمية باضطرابات اقتصادية واجتماعية، تخلّ بالاستقرار والسير الطبيعي لحياة المجتمعات وعمليات الإنتاج والتوزيع وغيرها، كما جرى في سورية، ويقود ذلك إلى البطالة وشحّ الموارد وارتفاع الأسعار والتحول في الإنفاق من الاستثمار والخدمات إلى التسليح وآلات الدمار، وعوضًا عن قوة العمل المنتجة ينمو الطلب على المقاتلين، ويفقد الاقتصاد توازناته وتكامله، ويصبح الإنفاق على آلة الحرب على حساب الاقتصاد الوطني واستعمال القطع الأجنبي في عملية استيراد الأسلحة والتجهيزات، وكلما تمددت الأزمة، تزايد الخلل في ميزان الإيرادات والنفقات، فمع تراجع الإيرادات بسبب الأزمة واستعمال الإيرادات لغايات لا تخدم النمو (تمويل الحرب) تنمو الحاجة باستمرار إلى تمويل الحروب أو معالجة آثار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ولسد هذه الفجوة، تلجأ الحكومات إلى طباعة مزيد من كميات النقد من العملة المحلية وضخها في الأسواق لتجنّب ازمة السيولة في الاقتصاد الوطني الذي يعاني الخلل بين الإنتاج والاستهلاك، مما يرفع من حجم الكتلة النقدية في التداول بأكثر بكثير من احتياجات الاقتصاد الوطني، وتصبح كتلة النقود الضخمة تقابل/ تطارد كميات محدودة من السلع والخدمات، وينشأ ما يسمى “التضخّم”، وتصبح العملة المحلية غير ذات قيمة بالنسبة إلى العالم الخارجي الذي ليس لديه أي ضمانة لمستقبلها، ومن ثم يحاول التخلّص منها بأسرع وقت، ولذا ترتفع الأسعار إلى أرقام فلكية، ويؤدي هذا إلى إفقار الطبقات الفقيرة أصلًا، وتدهور الفئات الوسطى إلى مستويات الفقر.
يمكنكم قراءة المادة كاملةً من خلال الضغط على علامة التحميل أدناه.