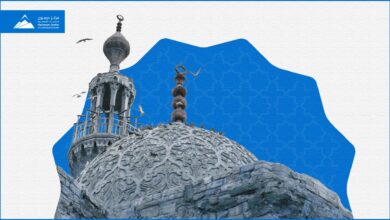شكل الدولة السورية الجديدة بين الواقع والمأمول
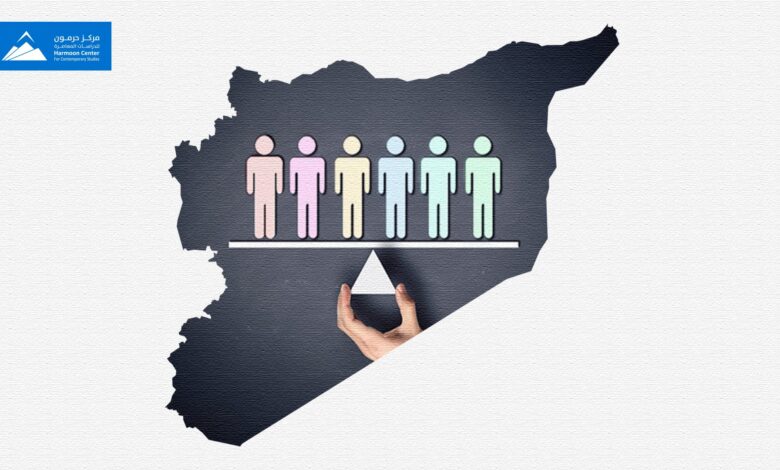
تنويه:
كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
أربع عشرة سنة مضت وقبلها عقود من القمع السياسي كانت فرصة للسوريين ليفكّروا على الأقل في شكل الدولة التي يحلمون بها. وبعد سقوط الحقبة الأسدية، تباينت الأفكار والرؤى بين المنظّرين في رسم سياسات الدولة السورية وعلاقاتها الداخلية والخارجية، حتى وصلت إلى درجة التنازع، في سياق الجدل العام والغليان الاجتماعي والأيديولوجي. والحقيقة أن أغلبها نابعٌ من النمذجة السياسية، وهو ما أعتقد أنه غير متناسب مع الحالة السورية، فمن وجهة نظري لا أرى نموذج حكم متكامل يصلح نسخه للحالة السورية.
وبعد تولّي السيد أحمد الشرع سدّة الحكم في سورية، بشبه توافق ثوري وحاضنة مجتمعية، ظهرت معالم الدولة الإسلامية لأول مرة في سورية بعد عقود طويلة من الزمن، وهو ما خلق بيئة ومساحة واسعة للجدل بين المنظرين. والواضح أنّ جميع المتجادلين حول شكل الدولة لا يتحدّثون عن الشيء نفسه؛ فالمفهوم عند كثيرين لا يشمل كلّ تلك المساحة التي يشغلها وجود الإسلام أو الدين عامّة، باعتباره رؤية مموّلة لتصوّر الإنسان للعالم، في كلّ التصوّرات التي تعتبره حجر الزاوية في بنائها النّظريّ للمجتمع المثاليّ.
فالمؤكّد أنّ الطريق المعياريّة، رغم بعض عناصر صلابتها النّظريّة، لا تحظى بكلّ الثقة؛ فكلّ انطلاق من مفهوم معيّن للدولة لا ينجو من التشكيك في تمحوره حول مركزيّةٍ ما. ويصدق هذا على من عرّف الدولة الدينيّة قياسًا على التعريف الحديث للدولة، فالسياسيون الشرعيون يرون أن ربط التشريع بالشريعة في الدولة الإسلاميّة لا يتنافى ومدنيّة السلطة، بداية من أبي الأعلى المودودي، وصولًا إلى القرضاوي والغنوشي اللذين يعتبران أن الدولة الدينيّة لم توجد إلاّ في تاريخ الكنيسة الأوروبيّة، على أساس أنّها الدولة التي يحكمها رجال الدين. ومن ثَم يستنتجون أنّ الدولة الإسلاميّة لا يمكن أن تكون دولة دينيّة؛ لأنّ الإسلام لا يعرف مقولة رجال الدين، ويدعمون تأكيدهم هذا بتعيين توافق الدولة الإسلاميّة مع الدولة المدنيّة، إذ يقرّون أنّ مصدر السلطة في الإسلام هو الأمّة، وإن لم تمتلك حقّ التشريع الذي يبقى بيد اللّه.
حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين:
إن طرح فكرة حيادية الدولة في مجتمع متعدّد ذي غالبية إسلامية لا يخلو من إشكال سياسي جدلي، فكما أن تطبيق إسلامية الدولة في الحالة السورية غير ممكن، فإنه من غير المقبول أيضًا علمنة الدولة أو أوربتها، وخاصة أن دستور الدولة الذي يحدد شكلها بحاجة إلى استفتاء شعبي، وهو ما لا يتناسب مع الغالبية المسلمة في سورية.
ومن هنا، لا بد -من وجهة نظري- من تأطير جديد لشكل الدولة السورية، وهو ما أعبّر عنه بالدولة المدنية ذات الفلسفة الإسلامية الحاكمة، وهذا ما نجحت فيه غالبية الدول الأوروبية التي انتهجت نهج علمانية الدولة مع المحافظة على المرجعية الدينية المسيحية، كاشتراط دين الحاكم، والحفاظ على الطابع الديني للدولة. وتشدّد بعضهم باشتراط المسيحية اللوثرية، وهو ما لم تفعله دولة إسلامية سوى إيران التي اشترطت المذهب الشيعي الإسلامي.
دولة مدنية أم إسلامية:
وهنا لا أقصد بمدنية الدولة علمانيتها الداعية لفصل الدين عن الحياة، ذلك المصطلح الذي نشأ مع نجاح الثورة الفرنسية، فلا يمكن قبول أي نظام سياسي إسلامي بمعزل عن الوحي، حيث إن غياب الوحي عنه يعتبر غيابًا لصفة الإسلامية. ومن جانب آخر، يطلق البعض مفهوم الدولة الدينيّة على أدنى التركيبات السياسيّة توظيفًا للدين في السياسة؛ فعلى هذا النّحو، يُنظر إلى كثير من الدول الغربيّة (العلمانية) على أنّها دول ذات أساس ديني.
أما الدولة المدنية، بمعناها الاصطلاحي الأشهر، وهو الدولة التي تديرها مؤسسات المجتمع المدني، فهذا ما يمكن أن يحل الإشكال الجدلي للحالة السورية، ولا سيما أن تلك المؤسسات هي التي تعبّر عن ثقافة الأمة، وتمثل المجتمع الذي ينبغي أن يؤسس لشكل دولته. فالدول المدنية بهذا المفهوم يمكن أن تكون حيادية، شريطة أن يأتي نظام الحكم فيها متوافقًا مع الرؤية الإسلامية ولا يعارضها.
لقد انتشرت مؤخرًا اتهامات كثيرة للإسلاميين بأنهم يناقضون الدولة المدنية، ويرفضون العيش في عالم متطور، ويريدون الانتكاس إلى دولة ثيوقراطية دينية تحكمها مبادئ إلهية صارمة غائبة عن الإنسان. ثم تطورت الاتهامات لدرجة جعلت المسلم نفسه يخشى من العيش تحت حكم الدولة الإسلامية، وذلك بالبحث عمّا يقيّد الحريات في الشريعة الإسلامية، وبالحديث عن الحدود وتطبيقها، كالقتل والقطع والرجم.
ولسائل أن يسأل هنا: كيف يقبل الإسلام بمبدأ مدنية الدولة، بمعنى أن تديرها المؤسسات الحيادية، تحت سقف الوحي؟ وكيف يجتمع حكم الوحي مع مدنية الدولة؟
هذا التسويق الفكري مبنيّ على مغالطة؛ لأن الإجابة ينبغي أن لا تكون على تسميات فحسب، بل ينبغي الإحاطة بالمضامين أيضًا، فولادة مصطلح المجتمع المدني المعاصر في حكومةٍ لا تحكمها المفاهيم الدينية لا يعني أبدًا أن فكرة المجتمع المدني لا تقبل التطبيق في مجتمع تحكمه الفكرة الدينية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، نجد أنه من غير الإنصاف أن يُنظر إلى الإسلام على أنه كتلة من المعلومات الوجودية التي تتكلم عن الغيب والحياة فحسب، فالإسلام نظام حياة يرتّب الاقتصاد والمجتمع والتعليم والجانب السياسي والعلاقات ما بين الأفراد، والعلاقات بين الدول. ومن غير السديد أن يُنظر إلى الإسلام ككثير من الأديان الأخرى التي تقتصر على المعلومات الوجودية والتعليمات الأخلاقية. فالإسلام نظام متكامل يمكن أن يملأ جوف الدولة المدنية.
إن النظام السياسي الإسلامي هو جملة من التدابير التي يفرضها الحاكم، مستندًا إلى مرجعيات معينة قد تكون الشريعة، وهي أهمها، وقد تكون الخبرات السياسية الأخرى المبنية على التجربة والاجتهاد. ومن هنا، نرى أن عمر بن الخطاب أوقف حد القطع في عام المجاعة، وأنكر الإمام محمد أبو زهرة وغيره من علماء المسلمين صحة ثبوت حالة الرجم الوحيدة في التاريخ الإسلامي، وغير المنصوص عليها في القرآن.
فعبارة تطبيق الشريعة، بفعل ارتباطها بهذا المفهوم الإسلاميّ الغالب للتوحيد، تمنع أيّ إمكان لانفلات الدولة من الدينيّة إلى المدنيّة، ولا تفلح مختلف التأويلات المتمسّكة بتأكيد مدنيّة الدولة الإسلاميّة.
وقد يكفي دليلًا على ذلك تبنّيها لقيم الدولة المدنيّة ومقولاتها، كالحريّة والمواطنة والديمقراطيّة، لا سيما أمام مفهوم حريّة المعتقد (لا إكراه في الدين) المناقض لحدّ الردة المختلف فيه عند علماء المسلمين. إنّ قراءة مفهوم الدولة في كتابات واحد من المفكّرين الإسلاميين تبين الرؤية الإسلامية لمدى إمكانية التزاوج بين السلطتين الدينية والمدنية. يقول المفكر الإسلامي فهمي هويدي، في كتابه الإسلام والديمقراطية: “نحن إذن نتحدّث عن سلطة مدنيّة منتخبة من ممثّلي الأمّة، والتزامها بشريعة الإسلام لا يُحوّلها إلى دولة دينيّة بالمفهوم السائد في التجربة الغربيّة… إذ يظلّ الدين مصدر القانون والقيم، وليس مصدرًا للسلطة بأيّ حال”، ويعتبر إغفال هذا التمايز الجوهريّ، بين الدولة الإسلاميّة والدولة المدنيّة، ناتجًا عن جهل بمصطلحات السياسة، فيقول: “إذا أردنا أن نحسن الظنّ بالذين وصفوا الدولة الإسلاميّة، بأنّها دولة دينيّة، ثمّ اعتبروها نقيضًا للدولة المدنيّة، فلن يكون أمامنا سوى مخرج واحد، هو إعذارهم، باعتبارهم لا يعرفون دلالة تلك المصطلحات، الأمر الذي أوقعهم في الغلط”.