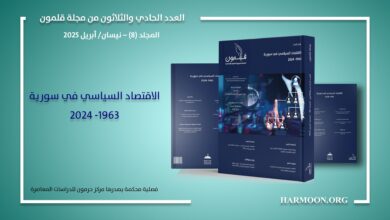حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية في السياق السوري: بين التحديات الثقافية والسياسية
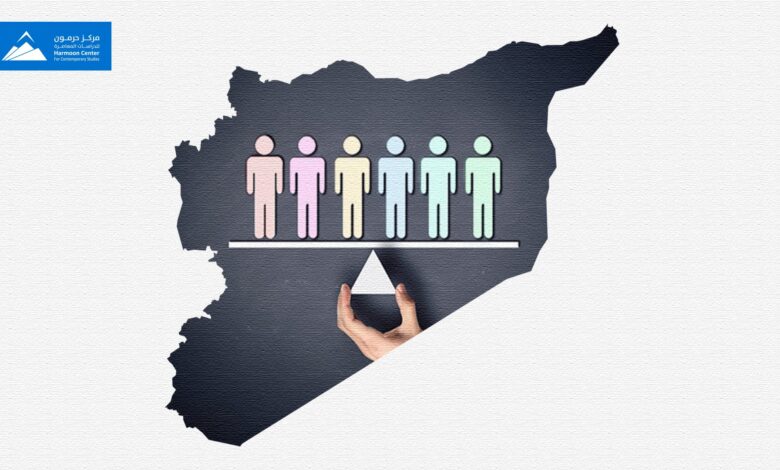
تنويه:
كُتِب هذا المقال بطلب من إدارة برنامج “حوارات السوريين”، وبمناسبة مشاركة الكاتب في جلسة حوارية لمناقشة موضوع “حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية للسوريين”. وهو يعبّر عن رأي الكاتب وموقفه من الموضوع.
رئيس التحرير
يعكس الواقع السوري الحالي مزيجًا معقّدًا من الحساسيات السياسية والاجتماعية، عندما يتعلق الأمر بعلاقة الدين بالدولة. هذا الموضوع يُثير كثيرًا من الجدل والانقسام بين السوريين، لا سيما بعد سنوات من القمع والاستبداد، ومع انفتاح المجال العام بعد الثورة، حيث أصبح بإمكان الأفراد التعبير عن آرائهم بحرية، في قضايا جوهرية مثل هوية الدولة ودور الدين في السياسة.
تزايدت حدة هذا النقاش في ظل تعددية المجتمع السوري، دينيًا وطائفيًا، وازدياد التوترات والصراعات ذات الطابع الطائفي، مما جعل أسئلة مثل “هل يجب أن تكون الدولة علمانية؟” أو “هل ينبغي أن تُحافظ على هوية دينية معينة؟”، أسئلة محورية في أي حديث عن مستقبل سورية.
من أبرز القضايا الخلافية، مسألة دين رئيس الجمهورية، حيث ينص الدستور السوري على أن يكون مسلمًا. هذا الشرط يُعدّه البعض إقصائيًا وغير منسجم مع مبدأ المواطنة والمساواة، في حين يراه آخرون ضمانة لهوية الدولة الإسلامية. ويبرز الجدل نفسه في مسائل رمزية، مثل ممارسة الطقوس الدينية داخل المؤسسات الرسمية، أو وجود رموز دينية في المرافق العامة، وهي أمور يعتبرها البعض تجسيدًا للحرية الدينية، ويراها آخرون خرقًا لمبدأ حياد الدولة.
أما في قطاع التعليم، فمادة التربية الدينية التي تُدرّس وفق انتماء الطالب (إسلامية أو مسيحية) تُعيد طرح تساؤلات حول جدوى هذا النهج، وحول إمكانية استبداله بمادة موحدة تُعنى بالقيم الإنسانية المشتركة، بغية تعزيز التعايش واحترام الآخر.
ورغم سقوط النظام، فإن كثيرًا من السوريين لا يزالون مترددين في التعبير عن رأيهم حيال حيادية الدولة تجاه الأديان، وذلك لأسباب ثقافية وشخصية ومجتمعية. ويمكن تحديد عوامل رئيسية تُفسّر هذا التردد:
العامل الأول: الإرث الثقافي والديني
تُعتبر سورية واحدة من أكثر الدول العربية تنوعًا دينيًا وطائفيًا، حيث احتضنت عبر التاريخ ديانات ومذاهب متعددة، بدءًا من الإسلام بمذاهبه المتنوعة (السنة، الشيعة، العلويون، الإسماعيليون)، والمسيحية بطوائفها المختلفة (الأرثوذكس، الكاثوليك، البروتستانت)، وصولًا إلى الدروز واليزيديين وغيرهم. هذا التنوع العريق لم يكن مجرد حالة اجتماعية سطحية، بل أصبح جزءًا جوهريًا من الهوية الفردية والجماعية للسوريين، وشكّل ما يمكن تسميته بـ “الذاكرة الثقافية الدينية” للمجتمع.
في هذا السياق، وفي مجتمع يتسم بالتقاليد المحافظة عمومًا، لم يعد الدين عقيدة روحية فحسب، بل غدا مكونًا ثقافيًا ونفسيًا يحدد الانتماء، وينظم العلاقات الاجتماعية، ويوجّه التصورات عن الدولة، والمواطنة، والعدالة. وقد أدى ذلك إلى نشوء حالة من “القداسة” المحيطة بالدين في الفضاء العام، بحيث أصبح من الصعب نقد الخطاب الديني أو حتى مناقشة دوره في الدولة والمجتمع، من دون أن يُقابل ذلك بالرفض أو الاستنكار أو حتى الاتهام بالمساس بالثوابت.
نتيجةً لذلك، يجد كثير من السوريين صعوبة في تقبّل فكرة حياد الدولة تجاه الأديان، فالعديد منهم لا يرون الدولة مجرد إطار قانوني وسياسي ينبغي أن يكون محايدًا ومنصفًا تجاه الجميع، بل يرونها “راعيًا للقيم الدينية”، و”حامية للهوية الدينية للمجتمع”. وبالتالي، يُنظر إلى الحياد على أنه تخلٍ عن هذا الدور التاريخي أو محاولة لإلغاء الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع.
من جهة أخرى، تلعب الأسرة، دور العبادة، والمدرسة، ووسائل الإعلام دورًا مهمًا في تكريس هذا التصور، خاصة من خلال التنشئة الاجتماعية والدينية المبكرة. ففي أغلب البيئات السورية، يتم تلقين الطفل منذ الصغر بأن الدين هو المصدر الأساسي للأخلاق والانضباط، وأن الابتعاد عنه يُهدد تماسك المجتمع. أما في المدارس، فإن مادة التربية الدينية -رغم الفصل الشكلي بين تعليم المسيحيين والمسلمين- تُقدَّم بطريقة تقليدية تُعزز الانتماء الديني، وتُكرّس التقسيم بين الطوائف، ولا تفتح المجال لنقاش فلسفي أو قانوني حول الحريات الدينية أو مفهوم الحياد.
وبالتالي، فإن النشأة ضمن هذا الإطار تُنتج أجيالًا ترتبط فيها فكرة الدولة بفكرة “الحَكم الديني” أو “الرعاية الدينية”، وليس “الحياد المنصف”. ومع تصاعد الخطاب الديني في المجتمع، خصوصًا بعد الثورة، تكرّس هذا التصور أكثر، وأصبحت أي دعوة إلى حيادية الدولة تُقابل بشك أو اتهام بأنها دعوة لتغريب المجتمع أو فصل الدين عن الأخلاق.
من الجوانب المهمة في هذا الإرث أيضًا، وجود نوع من القلق الجمعي لدى بعض المكونات الدينية، خاصة الأقليات، من أن أي حياد للدولة قد يعني التخلي عنهم أو تركهم في مواجهة التيارات الأقوى في المجتمع. ففي بلد متعدد الطوائف كـسورية، لا يرى كثيرون أن الحياد وحده يكفي، بل يعتبرونه أحيانًا مجرد “حياد شكلي”، قد يُستخدم كغطاء لهيمنة ثقافية أو دينية من طرف على آخر.
كذلك، هناك تصور واسع أن فصل الدين عن الدولة قد يؤدي إلى ضياع “المرجعية الأخلاقية”، أو إلى تقليد النماذج الغربية التي يُنظر إليها أحيانًا بعين الريبة، باعتبارها تُنتج مجتمعات مفككة أخلاقيًا. وهذا التصور يزيد من رفض فكرة الحياد أو الخوف منها، حتى بين فئات تعتبر نفسها “معتدلة” دينيًا.
العامل الثاني: التخوف من العلمانية
أحد الأسباب الرئيسية لرفض السوريين لمبدأ حيادية الدولة تجاه عقائد السوريين الدينية هو خوفهم من العلمانية، أو بالأحرى رفضهم لها، باعتبارها لا تمثل الهوية الثقافية للمجتمع السوري، حيث إن معظم السوريين يتخذون موقفًا معاديًا للعلمانية، ولا يرون فيها إلا تيارًا متحررًا يسمح بالمثلية الجنسية والانفلات الأخلاقي، مما يتعارض مع الإرث المتحفظ للمجتمع السوري.
لكن مبدأ حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية لمختلف مكونات الشعب السوري، أو ما أسميها موقف الدولة المتساوي من كافة العقائد الدينية للسوريين، بعيدٌ عن العلمانية، بمفهومها الشعبي والسياسي. بمعنى أن ينصبّ تركيز الدولة على الحياد وعدم التمييز على أساس الانتماء الديني، أي أن تمتنع الدولة عن تأييد أو تفضيل أي معتقد ديني محدد، وأن تتعامل الحكومة مع جميع الطوائف الدينية على قدم المساواة بموجب القانون، وتضمن حرية الأفراد في ممارسة أو عدم ممارسة دينهم دون تدخل. فمثلًا يمكن للدولة أن تتعامل مع المجتمعات الدينية في مسائل عملية، مثل توفير الأمن للتجمعات الدينية دون تأييد عقائدها أو مراقبة مصادر تمويل هذه التجمعات الدينية لمنع أي تمويل مشبوه أو تمويل خارجي ذي أهداف تهدد أمن الدولة أو أمن المجتمع السوري. ويتوجب على الدولة منع أي ممارسات دينية أو اعتقادية قد تتنافى مع المبادئ الثقافية وأخلاق الشعب السوري، مثل المثلية الجنسية أو مشاهد اللطم أو حتى رسائل الكراهية التي قد تنشرها مختلف الطوائف الدينية، من خلال بعض طقوسها أو خطاباتها الدينية الطقوس.
بالمقابل، تذهب العلمانية إلى أبعد من ذلك، حيث إنها تدعو إلى تمييز واضح بين الدولة والمؤسسات الدينية، وتفصل بحزم بين الدولة ونشاطها المؤسساتي والمجتمعي والرقابي بشكل كامل عن كافة المؤسسات الدينية وأملاكها وممارساتها ونشاطاتها. يهدف هذا الفصل إلى منع تأثير العقائد الدينية في سياسات الحكومة وقوانينها والتعليم العام. هذا الفصل التام غير قابل للتطبيق في سورية نظرًا للدور السياسي الذي ما زالت تلعبه التجمعات والطوائف الدينية، وتأثير هذا الدور في التوجهات السياسية للسوريين، حيث عمد الزعماء الدينيون لمختلف الطوائف على تسيس الدين، من أجل ضمان بقاء سلطتهم على أفراد الطائفة، ومن أجل بقاء الطائفة نفسها من وجهة نظرهم.
من جهة أخرى، غالبًا ما تؤكد العلمانية بشكل جوهري على العقل والأدلة والإنسانية كأساس للحكم والمعايير المجتمعية، ولكن تطبيق هذه المبادئ لم يظهر نجاحًا في أي من الدول التي تعتمد العلمانية كسياسة لها. فبينما يكون من المفترض أن تحمي الدولة الحرية الدينية، وأن تسعى أيضًا إلى الحفاظ على فضاء عام خالٍ من السيطرة الدينية، وتضمن معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو غير الدينية، فإن هذا غالبًا ما يطبق في معظم الدول العلمانية بطريق مباشر أو غير مباشر ضدّ دين محدد. أي أن الحيادية التامة تجاه جميع الأديان أمرٌ صعب التحقيق نوعًا ما.
العامل الثالث: الإرث الأسدي
لعب النظام الأسدي -في مرحلتي حافظ وبشار الأسد- دورًا حاسمًا في تأطير العلاقة بين الدولة والدين، حيث رسّخ ممارسات متناقضة مع الخطاب “العلماني” الذي تبناه شكليًا. هذا الإرث الاستبدادي ساهم في تشويه مفهوم حيادية الدولة، وأثّر بعمق في مواقف السوريين تجاه العلمانية ودور الدين في المجال العام.
تبنّى النظام الأسدي منذ السبعينيات خطابًا علمانيًا يدّعي الحياد تجاه الأديان والطوائف، ويؤكد منع تسييس الدين. غير أن الواقع كان مغايرًا تمامًا؛ فقد استخدم النظام الدين كأداة سياسية تخدم استمراره، من خلال التلاعب بالتوازنات الطائفية وتعزيز الانقسامات المجتمعية. فرغم الشعار العلماني، عمل حافظ الأسد -ثم بشار بعده- على ترسيخ هيمنة علويين في مؤسسات الدولة الحساسة، خصوصًا في الجيش والأجهزة الأمنية، في مقابل إدارة دقيقة لعلاقات باقي الطوائف بما يخدم استدامة السلطة.
كان هذا التوظيف السياسي للدين جزءًا من سياسة “فرّق تسد”، حيث تم استغلال التعددية الدينية لبناء شبكة ولاءات تقوم على التخويف المتبادل، لا على الانسجام المجتمعي أو المساواة أمام الدولة. ولم يتوقف الأمر عند حدود بنية السلطة، بل امتد إلى المجال الديني المباشر، حيث خضعت المؤسسات الدينية الرسمية لرقابة صارمة، وتم تعيين رجال دين موالين يتبنّون خطابًا يبرر الطاعة للنظام ويجرّم أي دعوة دينية إلى التغيير أو العدالة.
وقد أفضى هذا التسييس الصارخ للدين إلى نتائج مزدوجة: من جهة، زاد من نفور الفئات المؤيدة لفصل الدين عن الدولة بسبب استغلال الدين لتبرير الاستبداد؛ ومن جهة أخرى، عمّق مخاوف المتدينين من أن يكون أي حديث عن العلمانية مجرد غطاء آخر لقمع الدين، كما حصل تحت حكم البعث. وهكذا، ساهمت ممارسات النظام في تغذية الارتياب المتبادل بين التيارات العلمانية والدينية، وعطّلت إمكانات بناء توافق وطني حول طبيعة الدولة المنشودة.
وفي السياق نفسه، فرض النظام قيودًا مشددة على حرية التعبير والنقاش العام في قضايا مصيرية، كالعلاقة بين الدين والدولة، وحرية الاعتقاد، والحق في تغيير الدين أو عدم الانتماء لأي دين. وقد أفضى هذا القمع إلى تغييب ثقافة الحوار والانفتاح، وترك فراغًا فكريًا لا يزال يلقي بظلاله على المجتمع السوري حتى بعد اندلاع الثورة.
ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، برزت حاجة ملحّة إلى إعادة التفكير في شكل الدولة ومستقبل العلاقة بين الدين والسياسة. لكن النقاش حول حيادية الدولة ظل محاطًا بالحذر والقلق، لا سيما في ظل استمرار نفوذ فلول النظام في بعض المناطق، أو عودة بعض أساليبه عبر قوى محلية أخرى. لقد زرع الاستبداد الديني-السياسي العميق شكوكًا مزمنة في أوساط السوريين، جعلت من الصعب الوثوق بأي مشروع سياسي يتحدث عن الحياد الديني دون ضمانات حقيقية.
وقد انعكس هذا الإرث الاستبدادي حتى داخل صفوف المعارضة، حيث يتجلى الانقسام بوضوح بين من ينادي بدولة حيادية تفصل بين الدين والسياسة، وبين من يرى أن الهوية الإسلامية جزءٌ لا يمكن التنازل عنه. هذا الانقسام لا ينفصل عن تجربة السوريين مع نظام وظّف العلمانية لتبرير القمع، والدين لتبرير الخضوع، مما شوّه المفاهيم لدى الطرفين على حد سواء.
إن إرث النظام الأسدي في تسييس الدين وتطويعه لخدمة السلطة لم يقتصر على الماضي، بل ما زال يلقي بظلاله على الحاضر والمستقبل السوريين. فقد ساهم في خلق بيئة من الشك المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، وأعاق بناء تفاهم مشترك حول حيادية الدولة، كمبدأ يضمن العدالة والمساواة لجميع المواطنين. ومع استمرار الجدل حول العلمانية والدين، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل المفاهيم، وتحريرها من التشويه الذي ألحقه بها النظام، تمهيدًا لبناء دولة مدنية ديمقراطية، تحترم التعددية، وتحمي حقوق الجميع دون تمييز ديني أو طائفي.
العامل الرابع: العمر والموقع الجغرافي
يلعب كل من العامل العمري والموقع الجغرافي دورًا مهمًا في تشكيل مواقف السوريين تجاه حيادية الدولة في القضايا الدينية، نظرًا لتباين التجارب الحياتية والثقافية التي مرّ بها الأفراد، بحسب الجيل والمنطقة؛ فالأجيال الأكبر سنًا، التي عايشت حكم الأسد لعقود طويلة، تميل غالبًا إلى التحفّظ إزاء فكرة حيادية الدولة. فهذه الأجيال، التي تشبّعت بخطاب النظام الرسمي وتعرضت لقمع النقاشات الحساسة، غالبًا ما ترى أن مسألة الحياد الديني “نظرية” أو “خطرة” على التماسك المجتمعي، خصوصًا في ظل تجربة سياسية استُخدم فيها الدين للتلاعب بالمجتمع. وتميل هذه الفئة إلى تفضيل “الاستقرار” على الانفتاح على قضايا مثيرة للجدل، كالعلاقة بين الدين والدولة. وتُبدي رفضًا واضحًا لإلغاء مادة التربية الدينية من المناهج التعليمية، وتعتبرها ضامنة للقيم الأخلاقية والثقافية. بل إن بعض كبار السن يذهبون إلى حد الدفاع عن النظام الأسدي في تعامله مع الدين، معتبرين أنه كان “عادلًا” في هذا المجال، مقارنة بممارساته الأخرى، بل تراه “حاميًا للدين والعلاقات الطائفية”.
في المقابل، تُظهر الأجيال الشابة، خاصة أولئك الذين وُلدوا بعد عام 2000 أو نشؤوا في ظل الثورة والنزوح، ميلًا أكبر نحو مفاهيم الحريات الفردية، والمساواة، وحياد الدولة. فقد شكّلت تجاربهم مع الإعلام الجديد، والتفاعل مع مناهج تعليمية ومنظومات قانونية في بلدان اللجوء، واحتكاكهم بعوالم افتراضية مفتوحة على نقاشات فكرية متنوعة، عاملًا مؤثرًا في تبلور قناعات أكثر انفتاحًا. وغالبًا ما ترى هذه الأجيال أن حياد الدولة ضرورة لضمان العدالة وحماية جميع المواطنين دون تمييز.
أما من حيث الموقع الجغرافي، فيُلاحظ وجود تباين واضح بين مواقف سكان الريف والمدن الكبرى. ففي المناطق الريفية أو النائية، حيث ما تزال الروابط التقليدية والدينية تشكل أساسًا للهويات الفردية والجماعية، تسود مواقف أكثر تحفظًا إزاء حيادية الدولة، خوفًا من أن يُفهم ذلك كإقصاء للدين من الحياة العامة. أما في المدن الكبرى، مثل دمشق، حلب، وحمص -لا سيما قبل الحرب- فقد ساهم التنوع الديني والثقافي والتفاعل المجتمعي الواسع، في تعزيز تقبل مبدأ الحياد الديني، باعتباره أداة لحماية السلم الأهلي والتعددية.
وفي المناطق التي خضعت لسلطات مختلفة بعد الثورة -سواء أكانت جماعات دينية متشددة أم سلطات ذات طابع قومي علماني- فقد عايش السكان تجارب متناقضة أثّرت بشكل مباشر في مواقفهم. فبعضهم عزّز قناعته بضرورة حياد الدولة بعد أن رأى كيف يمكن لتسييس الدين أن يتحول إلى أداة قمع، في حين أصبح آخرون أكثر ارتيابًا من المفهوم، خشية أن يُستخدم مجددًا للهيمنة.
ولا يمكن تجاهل تأثير تجربة السوريين في بلدان اللجوء، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث لمسوا حيادية الدولة عن الدين في مؤسساتها وتشريعاتها. وقد ساهم هذا الاحتكاك بتلك النماذج في زيادة تقبلهم لفكرة الحياد، وفي رغبتهم في نقل هذه التجربة -أو على الأقل الاستفادة منها- إلى السياق السوري، مع إدراكهم لتعقيداته الخاصة.
إذا كانت كل هذه العوامل تلعب دورًا فاعلًا في حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية في المجتمع السوري، وفي مواقف السوريين المتضاربة من هذه الحيادية، فهل من الممكن إمساك العصا من الوسط وخلق نوع من الحيادية الجزئية التي تضمن موافقة جميع الأطراف، وتحقق في الوقت ذاته الحرية والمساواة بين جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم الدينية؟
الحيادية الجزئية:
في ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى صيغة مرنة للعلاقة بين الدولة السورية والعقائد الدينية للمجتمع، صيغة لا تفرض تصوّرًا قسريًا للعلمانية الصارمة، ولا تسمح بانزلاق الدولة إلى تسييس الدين أو فرض دين على حساب آخر. وهنا تظهر فكرة الحيادية الجزئية للدولة تجاه العقائد الدينية كحلّ وسط يوازن بين حرية المعتقد من جهة، وبين استقرار الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى.
والحيادية الجزئية لا تعني أن تُقصي الدولة الدينَ من الحياة العامة، كما في بعض النماذج العلمانية المتطرفة، بل تعني ألا تتبنى الدولة عقيدة دينية رسمية، ولا يفرض دين للرئيس أو هوية دينية للدولة، لضمان حقوق جميع المواطنين على حد سواء بالترشيح و التمثيل الحكومي، وألا تفرض شعائر أو رموزًا دينية في مؤسساتها العامة، بل أن تضمن لجميع المواطنين حق ممارسة شعائرهم الدينية بحريّة، سواء في المساجد أو الكنائس أو الأماكن العامة، ما دامت هذه الممارسة لا تخلّ بالنظام العام ولا تتعدى على حقوق الآخرين، ولا توثر على سير المؤسسات الحكومية أو على الحقوق الخدمية للمواطنين، وبذلك تفتح الدولة المجال أمام التعدد الديني والثقافي ليُعبَّر عنه في الحياة العامة بشكل سلمي ومدني، دون تمييز أو تهميش.
ضمان حرية الممارسة في الفضاء العام
وفق هذا التصوّر، تبقى الحرية الدينية مصانة، ليس فقط في المجال الخاص، بل في الفضاء العام أيضًا. يمكن للأفراد والمجموعات ممارسة شعائرهم وهويتهم الدينية بشكل علني، والمشاركة في الحياة العامة من منطلقاتهم الدينية، شرط احترام القوانين العامة وعدم فرض معتقداتهم على الآخرين أو على مؤسسات الدولة وعدم إثارة الكراهية والأفكار المغلوطة والعدائية عن باقي الأديان والطوائف. وهذا الشكل من الحيادية يعترف بأن الدين مكوّن أساسي من الهوية الثقافية لكثير من السوريين، ولا يمكن ببساطة إخراجه من المجال العام دون إثارة قلق شرائح واسعة من المجتمع.
ضبط العلاقة مع مؤسسات الدولة
لكن في المقابل، تحتفظ الدولة بحقّها في تنظيم الأداء والرقابة على أساس مدني وغير ديني، أي أن الموظفين في الدوائر الحكومية -بما في ذلك التعليم والإدارة والقضاء- يُلزمون بتقديم خدماتهم بعيدًا عن التحيّزات الدينية أو الطائفية. وتُمنع المؤسسات الدينية من التدخل في التشريع أو الحكم. وتلتزم الدولة بمنح الطوائف والتجمعات الدينية حرية ممارسة طقوسها وإدارة الأملاك التابعة لها، مع ضمان مراقبة لهذه النشاطات عن طريق مجلس يضم ممثلين عن كل الطوائف و الأديان، وذلك للحيلولة دون إيذاء المكونات الدينية الأخرى للمجتمع أو تحقيرها أو بث الكراهية أو حتى الاستناد إلى تمويلات مشبوهة أو الاستعانة بتمويلات معنوية ومادية خارجية قد تكون لها أهداف أخرى. هذا التوازن يتيح للمجتمع أن يعبّر عن تنوعه، دون أن تتحول الدولة إلى طرف في النزاع العقائدي، أو أداة لترجيح كفة طائفة أو دين على آخر.
حماية الإرث الثقافي السوري
الحيادية الجزئية تسهم كذلك في حماية التراث الروحي والثقافي المتنوع للمجتمع السوري، وتمنع محوه أو طمسه تحت أي ذريعة. فوجود إطار قانوني يعترف بالتعدد الديني، ويضمن حياد الدولة، يمنع محاولات الاستبعاد أو الإقصاء الثقافي، ويُسهم في بناء سردية وطنية جامعة.
تدريس مادة “المجتمع السوري” في المناهج التربوية
ولكي تُترجم هذه الرؤية إلى واقع تربوي وثقافي، من المهمّ إدراج مادة تربوية جديدة في المناهج الدراسية بعنوان “المجتمع السوري”، تهدف إلى:
التعريف بكافة أطياف المجتمع السوري: أديانه، مذاهبه، لغاته، وعاداته.
تسليط الضوء على القيم الأخلاقية المشتركة، مثل الكرامة، الاحترام، التسامح، والعدالة.
بناء وعي مدني مشترك يقوم على المواطنة، لا على الانتماء الديني أو الطائفي.
عرض تاريخ سورية الحديث والمعاصر من زوايا متعددة، مع توعية الطلاب بكيفية نشوء التوترات الطائفية، وكيف يمكن تجاوزها بمقاربة مدنية شاملة.
هذه المادة يمكن أن تكون ركيزة لزرع قيم الحوار والانفتاح في الأجيال الجديدة، بعيدًا عن الاحتقان الديني، وتُشكّل جسرًا بين الهويات المختلفة تحت مظلة وطنية جامعة.
ختاما نستطيع القول إنه يمكن للسوريين أن يؤسسوا لدولة تحترم الدين دون أن تستغلّه، دولة تعترف بمكانة الدين في حياة الأفراد والمجتمعات، من دون أن تضعه في موضع السلطة السياسية أو أن تستخدمه لتحقيق أغراض سلطوية. في هذه الدولة، تُحترم حرية المعتقَد كحقّ أساسي لكل فرد، حيث يكون لكل مواطن الحقّ في ممارسة دينه بحريّة، من دون أن يُحارَب أو يُستبعَد بسبب معتقداته. وفي الوقت ذاته، لا تفرض تلك الدولة أو أي جهة رسمية فيها عقيدةً دينيةً واحدةً، وتحفظ التنوّع الديني والثقافي في المجتمع.
الدولة التي يسعى السوريون إلى بنائها يجب أن تكون دولةً للجميع، لا تميّز بين المواطنين على أساس دين أو طائفة أو مذهب. الدولة التي تُبنى على المواطنة أساسًا، لا على الانتماء الطائفي، تعني أن الحقوق والواجبات متساوية بين جميع أفراد الشعب، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية. العدالة ستكون هي المبدأ الأساسي الذي يحكم توزيع الثروات والفرص، وليس الانتماء الطائفي أو الديني. في هذه الدولة، لا توجد امتيازات لفئة معينة ولا تهميش لفئة أخرى.
والحياد في هذا الإطار أساسي؛ فالدولة لن تأخذ موقفًا مواليًا لأي دين بعينه، بل ستلتزم بدور الضامن لحقوق المواطنين في جميع المجالات دون تفرقة. والحيادية تجاه العقائد لا تعني العداء للدين، بل حماية حقوق الأفراد من استخدام الدين، كأداة سياسية أو أيديولوجية لصالح جهة معينة. هذه هي الرؤية المستقبلية التي تمكّن السوريين من بناء دولة يسود فيها السلام الداخلي، ويُعزّز فيها التنوع، وتُحترَم فيها حقوق الإنسان.